حقوقيّ عربيّ، ومحامٍ في المملكة المتحدة. حاز البكالوريوس في الفلسفة والعلوم السياسيّة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، إلى جانب شهادة عليا في القانون من جامعة لندن.

بعد سنوات الرُّقاد النسبيّ التي أعقبت الانتفاضاتِ العربيّةَ بدءًا من العام 2011، عادت رياحُ التغييرِ لتعصفَ بالمنطقة من جديد - - من الخرطوم إلى الجزائر، مرورًا ببغداد وبيروت. اصطبغت السماءُ بتوهّج المشاعل والمفرقعات، قبل أن يأتي وباءُ الكورونا ليُخمِدَه من جديد وليعيدَ خلطَ جميعِ تصوّراتنا للمستقبل. هكذا تحلّلتْ جميعُ البديهيّات والمسلَّمات السائدة، والثابتُ الوحيد الآن هو أنّ ما بعد الكورونا ليس كما قبله - - بل إنّ الأزمات التي كانت قائمةً قبل قدومه من شأنها أن تتعمّقَ بسببه.
حاولنا في مقالٍ سابقٍ تبيانَ المسارات الحرجة التي تقف أمامها دولُ المشرق العربيّ اليوم – ولبنانُ والأردن على وجه الخصوص.[1]فعلى الرغم من وجود فوارق جوهريّةٍ في تركيبة النظام السياسيّ-الاجتماعيّ في البلديْن، فإنّه يمكن استشفافُ بعض القواسم المشتركة في جذور أزماتهما. وأهمُّ تلك القواسم: وجودُ خللٍ بنيويّ في تكوين الحياة السياسيّة في منطقة المشرق العربيّ ككلّ. فالنموذج القائم قد ترجرج تحت وطأة الركود الاقتصاديّ، واللامساواةِ المتصاعدة، واشتعالِ الشارع (وإنْ بشكلٍ متقطّع). ثم جاءت تبعاتُ وباء كورونا لتهدِّد بتوجيه الضربة القاضية إليه.
انطلاقًا من ذلك، نرى أنّ علينا، في محاولاتنا تصوّرَ مستقبلٍ مشترك أفضل، أن نتخطّى خطابَ "مكافحة الفساد" السطحيّ، لنتمعّنَ في جذور ذلك النموذج المنتِج للأزمات المتعاقبة. فظواهرُ الفساد ليست سوى عوارضَ للمرض الأساس، الذي يكمن في: التركيبة البنيويّة للنظام السياسيّ العربيّ، وتغييبِ الحياة السياسيّة والاجتماعيّة الفاعلة في المنطقة، والاستغلالِ الطبقيّ، والهيمنةِ الخارجيّة. ومن شأن ذلك الخطاب السطحيّ أن يَطمس الجذورَ البنيويّة لأزماتنا المتراكمة، فتبدو وكأنّها نتاجُ "سوء إدارةٍ" لا أكثر.
نستعرض هنا حالةَ الأردن في وصفها دولةً تفادت، حتى الآن، الوقوعَ في أزماتٍ قاسيةٍ مقارنةً بدول الجوار. ونلفت النظرَ إلى بعض قواسمها المشتركة مع لبنان، المتأزِّمِ أبدًا، محاولين استجلاءَ العوامل التي ساهمتْ في إفراغ الحياة السياسيّة فيهما وترسيخِ الأنظمة المُنتِجة للأزمات. ونخْلص إلى أنّ أيَّ إصلاحٍ لا يطاول الاختلالاتِ السياسيّةَ في مجتمعاتنا لن يشكِّلَ، في التحليل الأخير، أكثرَ من "حقنة مسكِّنٍ" موقّتة.
حالة الأردن: ركود، وبطالة، وشعور بانسداد الأفق
يعاني الأردن اليوم آثارَ جمودٍ اقتصاديّ طويلِ المدى، أهمُّ تجلّياته معدّلُ البطالة المتصاعد بلا هوادةٍ، وقد بلغ 19% في الربع الأوّل من العام 2019. وتقع وطأةُ هذه الظاهرة على عاتق الشباب بصورةٍ خاصّةٍ، إذ بلغ معدّلُ البطالة الشبابيّة 36.7% في العام 2019. وهو ما ولّد شعورًا لدى جيلٍ كاملٍ بأنّ آفاقَ المستقبل مسدودة، ولا خلاصَ إلّا بالهجرة. ومن شأن الإقفال العامّ الحاليّ، الناتجِ من أزمة كورونا، أن يفاقمَ هذا الوضعَ ويؤدّي إلى كارثة اقتصاديّة-اجتماعيّة كبرى لم نَشهدْ لها مثيلًا، ما لم تُتّخذ الإجراءاتُ اللازمةُ لتوفير الحماية الاجتماعيّة للفئات المستضعفة التي تبخّرتْ مداخيلُها بين ليلةٍ وضحاها.
وبالتوازي مع هذه التحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، يواجه الأردن أزمةَ انعدام الثقة بقدرة السلطات السياسيّة على معالجة حالة الركود المتجذّرة. والدليل الأكبر على أزمة الثقة هذه بروزُ (وتجدُّدُ) حركاتٍ احتجاجيّةٍ واسعةِ النطاق في مناطقَ ومجالاتٍ مختلفةٍ على مدى السنين الأخيرة، بدءًا بحَراك 2011، ومرورًا بحَراك 2018 الذي أطاح بحكومة هاني الملقي، وانتهاءً بإضراب المعلّمين في العام 2019.
والحقّ أنّه لا يمكن التصدّي للتحدّيات الاقتصاديّة المتراكمة من دون إصلاحٍ سياسيّ جذريّ يهدف إلى إعادة إحياء الحياة السياسيّة لتعزيز آليّات المحاسبة والشفافيّة والرقابة القانونيّة، وتوليدِ شعورٍ لدى عامّة الشعب بأنّهم شركاءُ فاعلون في مشروع بناء الدولة والوطن.

السلطات عمدتْ إلى تفريغ الحياة السياسيّة من مضمونها
الجذور البنيويّة: إجهاض الحياة السياسيّة واستبدالها بالعشائريّة و"مجلس الخدمات"
لتبيان الجذور البنيويّة لهذه الحالة المتأزّمة، علينا أن نتناول تاريخَ وتطوّرَ النظام السياسيّ-الاقتصاديّ القائم الذي أنتجها. وبينما يلجأ البعضُ إلى خطابٍ استشراقيّ ثقافويّ ليعزو ظواهرَ الفساد والجمود الاقتصاديّ والاجتماعيّ إلى طبائعَ أسطوريّةٍ مُتخيَّلةٍ ومختزَلة (مثل "العقل العربيّ" أو "الثقافة الإسلاميّة")، فإنّنا سنحاول هنا البرهنةَ أنّ هذه الحالة المستديمة تعود إلى جذرٍ سياسيٍّ محدّد: وهو أنّ السلطات السياسيّة عمدتْ عبر العقود إلى تفريغ الحياة السياسيّة من مضمونها، وإلى تكريس مناخٍ عامّ سمح بانفراد طبقةٍ حاكمةٍ بالسلطة وباستحواذها على الاقتصاد الوطنيّ من خلال الخصخصة وممارسات الفساد.
يشير الكاتب الأردنيّ شاكر جرّار إلى ثلاثة منعطفات تاريخيّة في مسار الحياة السياسيّة الشعبيّة في الأردن: حكومة سليمان النابلسي سنة 1956، وهبّة نيسان سنة 1989، وحَراك 2011.[2] ويحاجج أنّ السلطة في هذه المنعطفات أُجبرتْ "على تقديم تنازلاتٍ سياسيّةٍ على إثر حراك اجتماعيّ-سياسيّ أدّى إلى فتح الطريق لمسارٍ ديمقراطيّ كان من الممكن البناءُ عليه لو لم تنقلب السلطةُ نفسُها عليه وتقطع الطريقَ أمامه."
وفي رأينا أنّ علينا أن نضيفَ منعطفًا آخرَ، أسبقَ على المنعطفات الثلاثة أعلاه، ألا وهو مرحلةُ تأسيس الإمارة وثورة العدوان عام 1923. فقد ارتكزتْ إمارةُ شرق الأردن في بداياتها على ثلاثة عوامل أساسيّة لضمان بقائها في بيئةٍ مضطربة: أ) الرعاية الخارجيّة البريطانيّة، التي كانت مرتهنةً بشرط الاعتراف بوعد بلفور والانتداب البريطانيّ على فلسطين. ب) تأمين ولاء العشائر الكبرى من خلال توزيع المزايا (المموَّلة غالبًا من المساعدات البريطانيّة)، مقابل التعهّد بالحفاظ على استقلاليّتها النسبيّة من الدولة. ج) اجتذاب أبرز الاستقلاليين السوريين، عقب احتلال دمشق، بادّعاء استخدام الإمارة الوليدة لتكون قاعدةً سياسيّة لمشروع تحرير سوريا الكبرى.
في وسعنا أن نستشفَّ في هذه التركيبة الأوّليّة نموذجًا بدائيًّا للبنية السياسيّة-الاجتماعيّة التي طبعت الدولةَ الأردنيّةَ على مدى تطوّرها التاريخي: أي الدولة القائمة على الزبائنيّة السياسيّة وتوزيع المنافع والخدمات، إلى جانب أدائها دورَ الحَكَم بين الوحدات الاجتماعيّة المتنازعة. وتقف هذه البنيةُ على تناقضٍ تامٍّ مع أنموذج الدولة المركزيّة القائمة على مفهوم المواطَنة وتوفير الإطار القانونيّ والاجتماعيّ اللازم لدعم الإنتاج المحلّيّ وتأمين حاجات المواطنين من دون التمييز بين فئاتهم المتعددة.
اشتعلتْ هذه التناقضات في العام 1923حين قاد سلطان العدوان، زعيمُ تحالف عشائر البلقاء، تمرّدًا على حكم الأمير، مطالبًا بإنهاء سياسات التمييز بين العشائر المختلفة وتخفيف الضرائب وإقامة مجلسٍ تمثيليّ دستوري. كان ردُّ الأمير استرضائيًّا في بادئ الأمر، إذ وعد بالبحث في المطالب، وأقال الحكومةَ. لكنْ ما لبثت السلطةُ أن انقلبتْ على وعودها، واعتقلتْ سلسلةً من رموز المعارضة. ثمّ تفاقم الخلافُ إلى مواجهةٍ عسكريّة، فاستطاعت الإمارةُ الوليدة - بدعمٍ من قوّاتٍ عسكريّة بريطانيّة - سحقَ قوّات العدوان وإنهاءَ التحدّي العلنيّ لنموذج الحكم القائم.[3]،[4]
تمثّل المنعطفُ الثاني، وربّما الأبرز، في تجربة حكومة سليمان النابلسي سنة 1956. خرجتْ هذه الحكومة عقب وحدة الضفّتيْن، ونهوض حركةٍ وطنيّةٍ معارِضةٍ تكوّنتْ من القاعدتيْن الشعبيّتيْن الأردنيّة والفلسطينيّة، وترافقتْ مع موجةٍ عالميّةٍ للتحرّر من الاستعمار. في هذه الفترة، تأسّس كلٌّ من الحزب الشيوعيّ الأردنيّ وحزب البعث وحزب الجبهة الوطنيّة والحزب الوطنيّ الاشتراكيّ الذي ترأّسه النابلسي. وعلى أساس دستور 1952، جرت الانتخاباتُ الحزبيّةُ الحرّةُ الوحيدةُ في تاريخ الدولة، وأفرزت انتصارًا واضحًا للقوى الوطنيّة المعارضة. فكُلّف على إثرها النابلسي، بصفته رئيسَ أكبر كتلةٍ في البرلمان، بتشكيل حكومةٍ جديدة، فنالت حكومتُه ثقةَ المجلس بـ 39من أصل 40صوتًا.[5]
لكنْ بعد مرور ستة أشهر مضطربة، محلّيًّا وإقليميًّا، بدءًا بالعدوان الثلاثيّ على مصر، ومرورًا بإعلان "مبدأ آيزنهاور" المعادي لِما اعتبرتْه أميركا "المدَّ الشيوعيَّ" في المنطقة، وانتهاءً بتفاقُمِ الخلافات بين القصر والحكومة، أصدر الملكُ قرارًا بإقالة هذه الحكومة. وبعد إخفاق سلسلة محاولات لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقةَ المجلس النيابيّ والأحزاب، اتُّخِذ قرارٌ بإعلان الأحكام العرفيّة، وعُيِّن حاكمٌ عسكريٌّ عامّ، وحُلّت كافّةُ الأحزاب السياسيّة والنقابات المهنيّة والعمّاليّة.[6] وهكذا قُطع مسارُ التجربة الديمقراطيّة الوطنيّة، وجُمّدت الحياةُ السياسيّةُ والحزبيّةُ بالكامل، وأُحلّتْ مكانَها دولةٌ مبنيّةٌ على علاقاتٍ زبائنيّةٍ وعشائريّةٍ تفتقر إلى سمات المواطَنة والعمل الجماعيّ السياسيّ.
استمرّت هذه الحالةُ حتى أتى المنعطفُ الثالث، ألا وهو هبّةُ نيسان 1989، التي انطلقتْ بشرارة انتفاضة الطبقات المهمَّشة في مدينة "مَعان" في وجه سياسات التقشّف التي انتهجتْها حكومةُ زيد الرفاعي، والتي بدورها أجبرت السلطةَ على رفع الأحكام العرفيّة وإجراء انتخابات نيابيّةٍ جديدة والبدء في تحوّلٍ ديمقراطيّ متجدّد. لكنّ هذا المسار الإصلاحيّ لم يدمْ، إذ سرعان ما اصطدم بمشروع التطبيع مع "إسرائيل" ومعاهدة وادي عربة، وبرز شعورٌ بصعوبة تمرير معاهدة السلام هذه في الظروف السياسيّة التي سادت آنذاك. وهذا ما استدعى العملَ على تشكيل حكومة جديدة و"مجلس نوّاب طيّع،" على حد قول جرّار، أي التضييق على المسار الديمقراطيّ الذي أنجبته هبّةُ نيسان. وتمثّلَ هذا التضييقُ في حكومة عبد السلام المجالي، وفي وضعِها قانونَ انتخابٍ جديدًا صِيغَ لتحييد المعارضة الفعّالة وضمان تمرير المعاهدة ("قانون الصوت الواحد"). وبصورةٍ متناظرة، تمّ التراجعُ التدريجيُّ عن الإصلاحات التي نتجتْ من حراك العام 2011، ليُتوَِّجَ التراجعُ بالتعديلات الدستوريّة لعاميْ 2014 و2016.
من هذه النبذة التاريخية الموجَزة يتبيّن أنّ السلطة الأردنيّة تمكّنتْ في عدّة مراحل تاريخيّة من تعطيل مساعي التحوّل نحو بناء دولةٍ ديمقراطيّةٍ قائمةٍ على أسس المواطَنة. وفي اعتقادنا أنّ تغييبَ الحياة السياسيّة والاجتماعيّة الفعّالة، هذا، قد أنشأ بيئةً خصبةً لاستشراء الفساد وسوءِ الإدارة وتراكمِ الأزمات، وفتح المجالَ أمام طبقةٍ صغيرةٍ كي تستحوذ على الثروة الوطنيّة في غياب أيّ آليّاتٍ لمحاسبتها. يحاجج د. هشام البستاني أنّ السلطة نجحتْ في "تحويل الهدف الأساس لأيّ مشاركة سياسيّة من الشراكة في السلطة إلى الحصول على الحصّة الأكبر من المنافع التي تحتكر السلطةُ توزيعَها وإدارتَها (الأعطيات والهِبات، الوظائف الحكوميّة، المقاعد الجامعيّة، وغيرها)."[7] واستطاعت كذلك تحويلَ مجلس النوّاب من برلمان وطنيّ حزبيّ، يرتكز على المنافسة بين برامجَ ورؤًى سياسيّةٍ مختلفة، إلى مجرّد ساحةٍ من ساحات الصراع على الامتيازات والخدمات في الدولة.

السلطةُ الأردنيّة تعمل على إعادة إنتاج نفسها بتحويل الانتماءات الاجتماعيّة إلى وحداتٍ سياسيّةٍ متصارعة
ربما تكون أبرزُ وسيلةٍ تنتهجها السلطةُ الأردنيّة لإعادة إنتاج نفسها في هذه التركيبة هي عملها لتحويل الانتماءات الاجتماعيّة (كالعشيرة والمنطقة) إلى وحداتٍ سياسيّةٍ متصارعة على انتزاع الخدمات والمزايا، وذلك من خلال آليّاتٍ محدّدة. من هذه الآليّات:
- قوانينُ الانتخاب التي كرّست التفتّتَ الاجتماعيّ والتصويتَ على أسسٍ عشائريّة.
- حصرُ جغرافيّة البرامج السياسيّة في حدود دوائرَ انتخابيّةٍ محجّمة.
- تخصيصُ عددٍ من المنح الجامعيّة لكلّ نائبٍ كي يوزّعَها على قاعدته التصويتيّة.[8]
وغير ذلك من الوسائل التي تهدف إلى زرع اعتمادٍ تامٍّ على "هِبات" السلطة وخلق علاقةٍ وظيفيّةٍ مطْلقة مع النوّاب والسياسيين.
أنتج هذا النهجُ في الأردن صحراءَ سياسيّةً مفرغةً من أيّ مضمون، يسودها منطقُ الالتحاق بالدولة والتصارعِ على مزاياها. وترافق ذلك مع غيابٍ شبهِ مطلق للأحزاب والبرامج السياسيّة والمشاركة الفعّالة في صنع القرار الوطنيّ. وفي مثل هذه الصحراء، يصعب أن نتصوّر أيَّ إصلاحٍ اقتصاديّ فعّال يهدف إلى إعادة تكوين البنية الاجتماعيّة والاقتصاديّة على أسس الإنتاج وتأمين الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين: فالرقابة التشريعيّة منعدمة، والرقابة الإعلاميّة غائبة، والرقابة القانونيّة شكليّة لا أكثر.
حالة لبنان: تغييبُ المواطَنة لصالح الزعامات الطائفيّة والمحاصصة السياسيّة
نلاحظ هنا نقاطَ تلاقٍ لافتةً مع البنية اللبنانيّة المتأزّمة أبدًا، ولا سيّما في ما يتعلّق بظاهرة الطائفيّة السياسيّة. نكتفي هنا بالإشارة إلى أبرز عناوينها.
فلبنان اليوم يعاني سلسلةَ أزماتٍ تكاد لا تُحصى:
- أزمة سياسيّة عادت بقوّةٍ مع اندلاع انتفاضة 17تشرين الأوّل 2019.
- أزمة ماليّة أدّت إلى فرض قيودٍ غير شرعيّة على المُودِعين تسبّبتْ بتعرّض المواطنين للإهانة اليوميّة أمام المصارف.
- أزمة نقديّة متمثّلة في انهيار الليرة اللبنانيّة.
- أزمة بطالة متجذّرة.
- أزمة دَيْن عامّ بلغتْ ذروتَها مع الإعلان الرسميّ عن خيار عدم السداد، وذلك قبل أيّامٍ من اقتحام أزمة كورونا الساحةَ.
في ظلّ هذه الحالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة، يبدو النظامُ السياسيُّ اللبنانيُّ مشلولًا وغيرَ قادر على التصدّي الفعّال للتحدّيات الهائلة التي تواجهها البلادُ اليوم، نتيجةً لاختلالاته البنيويّة المتعدّدة.
"إنّ الحريّة الدينيّة في لبنان مرتبطةٌ بالنظام الطائفيّ الذي يَفرض على كلّ لبنانيّ أن ينتمي إلى طائفةٍ من طوائفه الرسميّة، فلا يبقى طليقًا في حياته الاجتماعيّة والسياسيّة خارج الإطار الطائفيّ الذي وُلد فيه أو انتسب إليه." وردتْ هذه العبارة حرفيًّا في القرار الصادر عن الغرفة الأولى لمجلس شورى الدولة في 15/7/2009، ردًّا على دعوى تقدّم بها شابٌّ لبنانيٌّ للمطالبة بإبطال قرار رفض شطب قيْده الطائفيّ عن وثائق الأحوال الشخصيّة.[9] تُقدِّم هذه العبارةُ برهانًا واضحًا على صحّة تحليل المفكّر الراحل مهدي عامل للدولة الطائفيّة، حين اعتبر أنّ الطائفة "ليست كيانًا ... ليست جوهرًا. ليست شيئًا. إنّها علاقة سياسيّة يحدِّدها شكلٌ تاريخيّ معيّن." فالطوائف ليست ظواهرَ طبيعيّةً، بل "ليست طوائفَ إلّا بالدولة. والدولة في لبنان هي التي تؤمِّن ديمومةَ الحركة في إعادة إنتاج الطوائف كياناتٍ سياسيّةً، بالدولة وحدها."[10]
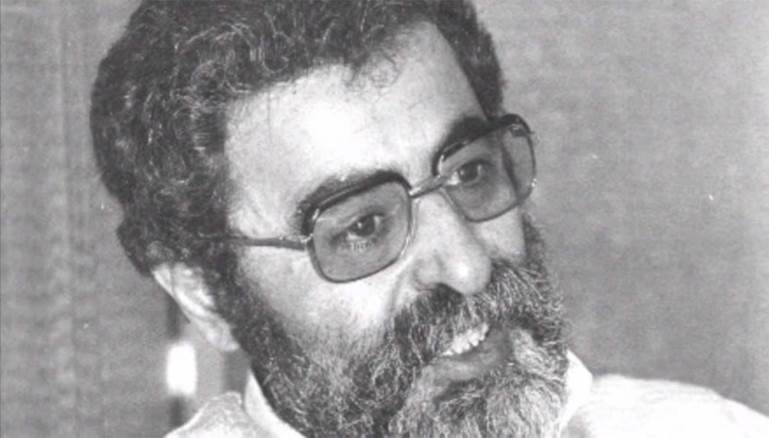
مهدي عامل: الطوائف ليست طوائفَ إلّا بالدولة!
إنّ هذه التركيبة المشوَّهة للدولة اللبنانيّة تشكّل العاملَ الأساسَ في تأزّمها المستمرّ. فنظامُها السياسيّ يخضع لمنطق انتماء الفرد إلى طائفة، ومن ثم تقرِّر الطائفةُ (باسم زعيمها) "الالتحاقَ" بالدولة. أي إنّ الطوائف هي الوحدات المكوِّنة للدولة، والمكوَّنة من الدولة، في آنٍ واحد. لا وجودَ لمفهوم "المواطَنة" في هذه المعادلة. ويترتّب على هذه التركيبة نموذجٌ اقتصاديٌّ زبائنيٌّ قائمٌ، في الأساس، كما في الأردن ولكنْ في صورةٍ مضخّمة، على الاستدانة الأبديّة وتوزيعِ المزايا والخدمات بناءً على أسس المحاصصة والتنازع بين زعماء الطوائف.
ومن البديهيّ القول إنّ المواطنَ الفقير لا يرى شيئًا يُذكَر من هذه المزايا، على الرغم من الاستشهاد باسمه و"حقّه" من قِبل الزعيم، الذي باتت ثروتُه فاحشةً نتيجةً لهذا "الصراع" المصطنع. لا بل على ذلك المواطن أن يتحمّلَ الآلامَ المأساويّةَ المترتّبةَ على انفجار الفقاعة، كما نرى اليوم.
خاتمة
تقف الدولُ العربيّةُ الآن أمام خياراتٍ حرجة. فقد باتت أزماتُنا المتعاقبةُ تستعصي على الإحصاء، وراحت أزمةُ الكورونا تهدِّدُ بتعميق هذه الأزمات وبإطلاق عاصفةٍ غير مسبوقة من الفقر والتفتّت الاجتماعيّ والاضطراب.
وإذا كان هناك أيُّ شكٍ متبقٍّ في استدامة العقد الاجتماعيّ القائم، في ظل الاندلاع المستمرّ للانتفاضات الشعبيّة على مدى السنين، فإنّه قد تحلحل الآن في وجه التحدّيات الهائلة التي فرضتها تبعاتُ هذا الوباء.
علينا الآن أن نبنيَ شيئًا جديدًا. وعلينا أن نتخطّى الآفاقَ المحدودة المتمثّلة في خطاب "مكافحة الفساد"؛ فهذا خطابٌ يُخفي الخللَ البنيويَّ المنتِجَ للأزمات. لا بديلَ من إعادة إحياء الحياة السياسيّة والاجتماعيّة الفعّالة على أسس المواطَنة والمشاركة الديمقراطيّة في بناء الوطن. ففي غياب المؤسّسات السياسيّة التمثيليّة العابرة للوحدات الاجتماعيّة، ستبقى محاولاتُ "الإصلاح" الاقتصاديّ والاجتماعيّ محكومةً بالفشل، إذ سوف تصطدم حتمًا بمساعي الطبقات الحاكمة (المستحوِذة على السلطة السياسيّة والاقتصاديّة) إلى إعادة إنتاج هيمنتها.
لا بدّ من "قرع جدران الخزّان،" على ما ناشدنا المناضلُ الشهيد غسان كنفاني في روايته الشهيرة، رجالٌ في الشمس. بكلماتٍ أخرى: لا بدّ من أن نلتزم البحثَ عن حلولٍ جماعيّة بنيويّة لأزماتنا العميقة المتمادية والمتكرّرة، بدلًا من الاستسلام لوطأتها الشديدة و"معالجتها" بأوهى المسكِّنات الآنيّة.
لندن
[2] https://www.7iber.com/politics-economics/obstructing-jordanian-democracy-removing-sulayman-nabulsi/
[3]Kamal Salibi, The Modern History of Jordan, I.B. Tauris, 1998
[4]ورقة تاريخية: ثورة العدوان، مدونة الباحث محمد أبو رمّان
[5]Avi Shlaim,The Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace (Vintage Books, 2007), Chapter 7: A Royal Coup
[6]ibid
[10] مهدي عامل، في الدولة الطائفيّة (بيروت: دار الفارابي، 1986).
حقوقيّ عربيّ، ومحامٍ في المملكة المتحدة. حاز البكالوريوس في الفلسفة والعلوم السياسيّة والاقتصاد من جامعة أكسفورد، إلى جانب شهادة عليا في القانون من جامعة لندن.










