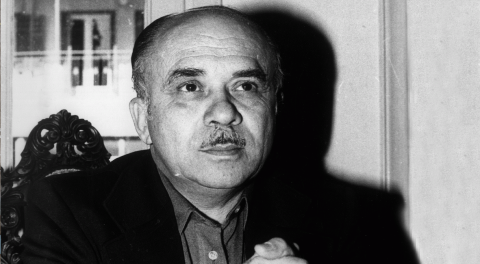أسامة حماد
مدون فلسطيني من غزة
.
محمود أبو ندى
كاتب فلسطيني من غزة

في شباط الماضي صدرتْ دعواتٌ على مواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل تنفيذ "مسيرات عودة" في 30 آذار، تنطلق نحو السياج الفاصل بين غزّة والأراضي المحتلّة، وتبلغ ذروتَها الحاسمة في الخامس عشر من أيّار، يوم النكبة. وكانت هذه الدعوات قد استندتْ إلى تجاربَ سابقة، أبرزُها مسيرةُ العودة في مجدل شمس (الجولان السوريّ المحتلّ) في العام 2011.
في 17 آذار عقد منسّقُ الهيئة العليا للمقاومة الوطنيّة والإسلاميّة في غزّة، القياديّ في حركة الجهاد الإسلاميّ، خالد البطش، مؤتمرًا صحفيًّا بالقرب من حاجز المنطار (كارني)، وبمشاركة أعضاء آخرين. فأَعلن تشكيلَ "الهيئة القياديّة العليا لمسيرات العودة وكسْر الحصار." وكان من أولى مَهامّ هذه الهيئة البدءُ بالتحضير لفعاليّات مسيرات العودة المذكورة. وكان منظّمو هذه المسيرات قد شدّدوا، في أوقاتٍ سابقة، على "سلميّتها" وعدم لجوئها إلى "أعمال عنف." كما أكّدوا أنّ حقّ العودة مرتكِز، بشكلٍ أساس، إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، المتمثّلة في قرار الأمم المتحدة رقم 194. وبناءً عليه حُدّدتْ نقاطُ التظاهر الأساسيّة بمئات الأمتار البعيدة عن السياج الفاصل، حيث نُصبتْ "خِيامُ العودة" وأقيمتْ بالقرب منها نشاطاتٌ اجتماعيّة وثقافيّة ورياضيّة.
في هذه المقالة سنرصد خلفيّاتِ المسيرة والظروفَ التي رافقت الدعوة إليها. كما سنَعرض تحليلًا نشرح فيه مدى استجابة الفلسطينيين في غزّة لها، وكيفيّةَ تعامل المتظاهرين مع العنف الإسرائيليّ المتصاعد.
الاحتلال: بين دقّ الإسفين ورصاص القنّاصة
مع انطلاق دعوات المشاركة في المسيرة بدأ الاحتلالُ بتوجيه تهديداتٍ متلفزة، وإلقاء منشورات على مخيّمات العودة تُحذّر من هذه المشاركة أو الاقترابِ من السياج أو القيامِ بأعمال عنفٍ ضدّه. كما حملتْ تلك المنشوراتُ والتهديدات تحريضًا على المقاومة الفلسطينيّة في غزّة و"حُكْمِ حركة حماس،" المُتسبِّبِ الرئيسِ ــــ بحسب ادّعاء الاحتلال ــــ في ما آلت إليه الأوضاعُ السياسيّة والاقتصاديّة في غزّة اليوم.
هذا وشملت التهديداتُ شركتَي النقل في غزّة، إذ حذّرهما الاحتلالُ من المشاركة في نقل المتظاهرين إلى المناطق الحدوديّة وإلّا تعرّضتا لأضرارٍ وخيمة. كما اخترق الاحتلال هواتفَ الشركتيْن، فأرسل رسائلَ نصيّةً تتضمّن مواعيدَ خاطئة لانطلاق الباصات إلى هناك. ونشر من خلال عملائه في غزّة إشاعاتٍ تُرهب الغزّيين وتثنيهم عن المشاركة في المسيرة. والهدف من ذلك كله دقُّ إسفين بينهم وبين تنظيمات المقاومة. غير أنه لم يفلح في ذلك.
وسعيًا إلى ترهيب المشاركين في مسيرة العودة، نَشر الاحتلالُ وحداتٍ عسكريّةً إضافيّة، إلى جانب أكثر من مئة قنّاص يعود معظمُهم إلى الوحدات الخاصّة التابعة للجيش الإسرائيليّ. وبموازاة ذلك، أنشأ نقاطَ مراقبةٍ جديدة، ووضع أسلاكًا شائكةً على طول الحدود، وخصوصًا في نقاط الاشتباك المعهودة، وجَهّز سواترَ ترابيّةً لتحصين مواقع القنّاصة. وأكّد الاحتلال أنّ الأوامر التي أعطيتْ إلى الجنود تَنصّ على وجوب استخدام قوّة كبيرة في مواجهة المتظاهرين ــ ــ وهو ما ظهر في الجمعة الأولى من مسيرات العودة، إذ استخدم القنّاصةُ الرصاصَ الحيّ والمطّاطيّ، والغازَ المسيل للدموع (أحيانًا عبر رشّه من طائرات فانتو مسيَّرة). وقد أدّى ذلك إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وإلى حالات إجهادٍ وتشنّجاتٍ وتقيّؤ وسعالٍ وتسارعٍ في نبضات القلب نتيجةً للتسمّم بغاز السيانيد، بحسب وزارة الصحّة في غزّة.

عودة العمل الشعبيّ: الأسباب
بعد سنوات طويلةٍ من الانقطاع، عاد العملُ الشعبيّ إلى تصدّر المواجهة مع العدوّ. فمنذ انسحابه الأحاديِّ الجانب من قطاع غزّة سنة 2005 لم نشهد عملًا مقاومًا جماعيًّا بهذا الشكل. ولا يعود ذلك، في الأساس، إلى تراجع الروح النضاليّة، وإنّما إلى القيود التي وضعها العدوّ ــ ــ ومنها إنشاءُ منطقةٍ عازلة، مدعومةٍ بسياجٍ أمنيّ، ومشبوكةٍ بمنظومة مراقبة متطوّرة.
وكانت المقاومة المسلّحة قد خاضت حروبًا شرسة استطاعت أن تعيدَ إلى هذه المنطقة العازلة بعضَ السيطرة الفلسطينيّة. هذا إضافةً، بالطبع، إلى الأنفاق الهجوميّة، التي نقلتْ جزءًا من المعركة إلى ما خلف السياج الفاصل خلال حرب العام 2014. كما أنشأت المقاومة شارع (جكر) لربط نقاط التماس المختلفة على طول السياج الفاصل؛ وهو ما ساهم في كسر هيمنة الاحتلال المطلقة على المنطقة العازلة، وأعطى الغزيّين شيئًا من المرونة في استعادة زخم العمل الشعبيّ المباشر ضدّ الاحتلال. هذا، وكان الغزيون سنة 2015 قد أطلقوا مظاهراتٍ في الضفّة والقدس إثر عمليّةٍ نفّذتها كتائبُ القسّام بالقرب من مستوطنة إيتمار.
إلّا أنّ نشاطات الغزّيين على طول الحدود خلال السنوات الثلاث السابقة لم تمتلكْ زخمًا كالذي امتلكته مسيراتُ العودة الكبرى. وكانت فكرة "مسيرة العودة" ستلاقي آنذاك اعتراضًا جوهريًّا ينطلق من تخوّفٍ منطقيّ من رد فعل الاحتلال العنيف. ولأنّ الظروف التي سبّبتْ هذا الاعتراضَ مازالت قائمة، فلا بدّ من البحث عن أسباب وضع فكرة "مسيرة العودة " موضعَ التنفيذ اليوم بالذات.
في هذا الصدد لا بدّ من الحديث عن المظاهرات (المحدودة) أوائلَ كانون الأول احتجاجًا على القرار الأمريكيّ نقلَ السفارة الأمريكيّة من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وفي هذا الوقت بالذات، زادت وتيرةُ الكشف عن أنفاق المقاومة (4 أنفاق اكتُشفتْ خلال العام الجاري)، وأحدُها كان يصل قطاعَ غزّة بمصر عبر حاجز كرم أبو سالم الحدوديّ. وقد ردَّت المقاومة على النشاط المتزايد لكشف الأنفاق، ففجّرتْ في منتصف شباط الماضي عُبوةً ناسفةً على السياج الفاصل. إلى ذلك استهدف شبّانٌ في منتصف آذار الماضي إحدى الحفّارات التي يستخدمها الاحتلالُ في الكشف عن الأنفاق.
أمّا على الصعيد السياسيّ، فلم تثمر شهورٌ طويلة من مساعي التقريب بين حركتيْ حماس وفتح، وانهارت مباحثاتُ المصالحة عقب التفجير الذي استهدف موكبًا تابعًا لحكومة السلطة ضمّ رئيسَ الوزراء ومديرَ المخابرات أثناء زيارتهما غزّة، وقد حمّلت "فتح" حركة حماس المسؤوليّة.
إضافةً إلى الظروف الميدانيّة والسياسيّة، يمرّ قطاعُ غزّة بظرفٍ إنسانيّ بالغ الخطورة. فالقطاع الذي يعيش حصارًا متواصلًا منذ أحد عشر عامًا يعاني تدهورًا في القطاع الاقتصاديّ؛ وفي البنية التحتيّة (بما فيها المباني المعرّضة للانهيار بفعل الحروب المتكرّرة)؛ وفي الوضع البيئيّ. كما أنّ تلوّثَ المياه الجوفيّة انعكس على صحة الغزّيين. وبحسب تقارير أمميّة فإنّ نسبةَ السرطان في القطاع بلغت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية. وكانت هذه التقارير قد حذّرتْ من تحوّل القطاع إلى مكانٍ غير صالح لحياة البشر بحلول العام 2020.
هذا وكان للتدابير التي اتخذتها سلطةُ أوسلو دورٌ كبيرٌ في تشديد وطأة الحصار على الغزّيين. فقد قامت السلطة مؤخّرًا بخصم رواتب موظّفيها، وهي رواتبُ تشكّل دعامةً أساسيّة لما تبقّى من اقتصادٍ منهارٍ في غزّة، وهدّدتْ بقطعها بشكلٍ كامل، وأعادت فرضَ الضرائب التي أُعفيَ منها القطاع حين تولّت قيادتَه حركةُ حماس في العام 2007. وكان أبو مازن قد كرّر تهديدَه المبتذل بإعلان غزّة إقليمًا متمرّدًا.
كلُّ تلك الظروف تُظهر أنّ الوضع في غزّة كان يتّجه نحو انفجارٍ جديد، وبوتيرةٍ متسارعة. وإذ راحت المقاومة تخسر مزيدًا من قدراتها، فإنّه لم يكن يُحتمل أن تتجدّد المواجهةُ العسكريّة المباشرة مع الاحتلال في هذا الوقت. وبدا أنّ تفعيلَ التبادل بين المقاومة المسلّحة والشعبيّة قد بات أمرًا مُلحًّا.
وَظّفتْ فصائلُ المقاومة كلَّ ثقلها من أجل الدعوة والحشد للمسيرة. فنظّمتْ أذرعُها الإعلاميّة والاجتماعيّة حملةً مكثّفةً لإيصال الدعوة إلى أكبر عددٍ ممكنٍ من الناس. وكانت فصائلُ العمل المسلّح قد باشرتْ نشرَ دعوتها إلى مسيرة العودة الكبرى في الثلاثين من نيسان. وثمَّة إجماع على أنّ تبنّي الفصائل الدعوةَ إلى المسيرة كان العاملَ الأساسَ لكسبِها هذا الزخمَ الشعبيّ. صحيح أنّ الدعوة أُطلقتْ أساسًا من حسابات ناشطين مستقلّين على وسائل التواصل الاجتماعيّ، إلّا أنّ فصائل المقاومة كان لها الدورُ الأبرز في نشر الدعوة وتنظيم المسيرة، وذلك بفضل إمكاناتها اللوجستيّة المتوفّرة. ويعود دورُ المقاومة الطاغي في القطاع الى سيطرة حركة حماس، وإلى تحرّر القطاع من قبضة حركة فتح التي كانت تشدّد رقابتَها على التظاهرات.
عن "السلميّة"
هنا لا بدّ من توضيح نقطةٍ قد تكون مثارَ خلافٍ بشأن ما ورد أعلاه. فالهيئة القياديّة العامّة للمسيرة ــــ بما فيها فصائلُ المقاوَمة ــــ شدّدتْ دومًا على رفض العنف استراتيجيةً للعمل. فالخيام التي نُصبتْ في "مخيّمات العودة" كانت بعيدةً عن السياج الفاصل. كما أنّ ساحة التظاهر صُمّمتْ لتكون مسرحًا لنشاطاتٍ اجتماعيّةٍ ورياضيّة، وذلك منعًا لانخراط الناس في مواجهة عنيفة مع الاحتلال. وكانت قياداتُ الفصائل قد أرسلتْ رسائلَ عديدةً تؤكّد نهجَها "السلميّ": فظهرتْ بعضُ قيادات حركة حماس على منصّةٍ نُصِبتْ بالقرب من إحدى نقاط التماس، وفي خلفيّتها صورٌ لشخصيّات معروفة للإعلام الغربيّ باعتبارها أيقوناتٍ للنضال اللاعنفيّ. كما أنّ من أبرز النشاطات الاجتماعيّة التي قُدّمتْ في تلك الخيام محاضراتٌ وورشاتُ عملٍ تهدف إلى تعليم المتظاهرين أساليبَ المقاومة اللاعنفيّة وتكتيكاتها.
غير أنّه بدا واضحًا من تصريحات منظّمي المسيرة وجودُ خللٍ في فهم بعضهم لمصطلح "السلميّة." فقد عبّر المستقلّون و"مؤسّساتُ المجتمع المدنيّ" عن رفض أيّ ممارسةٍ عنفيّة في المسيرة، بما في ذلك رميُ الحجارة. وجرى التأكيدُ على ضرورة الاكتفاء بالتظاهر قبالة السياج الفاصل وسيلةً لإحراج الاحتلال أمام المجتمع الدوليّ.
لكنْ، وتحرّيًا للدقّة، لا يمكن وصفُ مسيرات العودة بـ"السلميّة،" وخصوصًا مع ما اكتسبه هذا المصطلحُ من دلالاتٍ مناهضةٍ لوسائل المقاومة العنيفة. ولقد كان تحوّلُ المسيرة إلى مقاومة شعبيّة شبه عنفيّة أمرًا حتميًّا؛ ذلك أنّ أيّة محاولة للسيطرة على طبيعة الفعل المقاوِم ضدّ الاحتلال خلال المسيرة ضربٌ من الخيال. ولأجل هذا السبب بالذات، حشد الاحتلالُ طاقتَه العسكريّة على حدود غزّة، فحاول قمعَ المسيرة قبل أن تنطلق، مستهدفًا المُزارع الشهيد، عُمر سمور، في أرضه شرق خان يونس بقصفٍ مدفعيّ. لذلك، فإنّ لجوء المشاركين إلى "العنف الجزئيّ" (رمي الحجارة) قد كان ردّة فعلٍ طبيعيّةً على استخدام الاحتلال للقتل المباشر.

أساليب المواجهة
أظهر المشاركون في المسيرة مرونةً عاليةً في التصدّي لقمع الاحتلال. فقد وظّفوا أساليبَ وأدواتٍ قديمةً، وطوّروا أساليبَ جديدةً ومبتكرةً تناسب ظروفَ ميدانهم الخاصّ. وقد ساهم ذلك في إعطاء المسيرة المزيدَ من الزخم والكثافة، على عكس ما سعى إليه الاحتلال، الذي ظنَّ أنّ رفعَ حصيلة الشهداء والجرحى في اليوم الأول قد يؤدّي إلى خفض عدد المشاركين في الأيّام التالية.
وقد لاحظ المشاركون التأثيرَ الإيجابيّ للدخان، الناتجِ من حرق إطارات الكاوتشوك قبالة السياج الفاصل ـــ ـــ وهي وسيلةٌ استُخدمتْ في العمل الشعبيّ في فلسطين منذ وقت طويل. وظهرتْ للمشاركين شراسةُ الاحتلال ضدّ الشبان الذين نقلوا وأشعلوا الكاوتشوك قرب السياج خلال الجمعة الأولى. وتحوّلتْ صورةُ الشهيد عبد الفتّاح عبد النبي، التي التُقطتْ له قبل استشهاده بلحظات وهو ينقل الكاوتشوك ناحيةَ السياج بقصد إشعاله، إلى أيقونةٍ للجمعة التالية، "جمعة الكاوشوك." فانتشرتْ حمّى الكاوتشوك في غزّة، وجُمعت التبرّعاتُ من الناس لشراء الإطارات ونقلها إلى السياج لاستخدامها في الجمعة التالية. وبلغ من تأثيرها أن أصدر الاحتلال في اليوم ذاته قرارًا بمنع إدخال الكاوتشوك إلى غزّة.
ومثلما حاول المتظاهرون حمايةَ أنفسهم من قنّاصة الاحتلال عبر استخدام الكاوتشوك، فقد طوّروا أيضًا أساليبَ هجوميّةً لزيادة أضرار الاحتلال. فكان أن وظَّفوا الطائراتِ الورقيّة في نقل موادّ مشتعلة عبر السياج، نجحتْ خلال نيسان في إضرام النار بمئات الدونمات الزراعيّة حول كيبوتسات "غلاف غزّة" ومستوطناته.
ومؤخّرًا بدأ متظاهرون باستخدام بالونات من الهيليوم عوضًا من الطائرات الورقيّة.
هذا فضلًا عن القَطْع المستمرّ لأجزاء من السياج الفاصل، وهو ما تحوّل إلى ممارسة أساسيّة في المسيرات.
وأمّا ذروة نشاطات المتظاهرين فتمثّلتْ في اقتحام حاجز كرم أبو سالم، وإحراقه بالكامل، ما ألحق أضرارًا ماديّةً جسيمةً بمَرافقه.
خاتمة: نحو تعزيز الاشتباك
يُلاحَظ ما في هذه الممارسات من درجة عالية من التنظيم الذاتيّ، المعتمد على لامركزيّة القيادة. فلم تتدخّلْ قياداتُ الفصائل في توجيه المتظاهرين إلى الخطوات التي اتخذوها ضدّ الاحتلال. كما اتسمتْ ممارساتُهم بالسلاسة والمرونة، وبأنها تعلّمتْ من أخطائها ومَواطنِ القصور فيها، وطوّرتْ نفسها بشكل ذاتيّ. ولقد قسّم المشاركون أنفسَهم إلى مجموعات، اختصّت كلٌّ منها بمهامّ محدّدة، من دون الحاجة إلى قيادة موحّدة أو سلسلة أوامر.
لا يجعل ذلك كلُّه من هذه المسيرات حالةً فريدةً من نوعها؛ فهي حالة عامّة تسم الحراكاتِ الثوريّةَ الشعبيّة. لكنّها ممارسات تكشف عن امتلاك الغزّيين ما يكفي من الوعي لحسم خيارهم في استخدام العنف الثوريّ لمواجهة الاحتلال، وبرهنوا أنّ أيّ انفراج في الحيّز العامّ للعمل الشعبيّ المغلق أمامهم منذ ثلاثة عشر عامًا سيُستخدم لتعزيز وتيرة الاشتباك مع المحتلّ.
فلسطين
*ينشر هذا المقال بالتعاون مع "اتجاه" وهي نشرة دورية تصدرها مجموعة "نبض" الشبابيّة.
أسامة حماد
مدون فلسطيني من غزة
.
محمود أبو ندى
كاتب فلسطيني من غزة