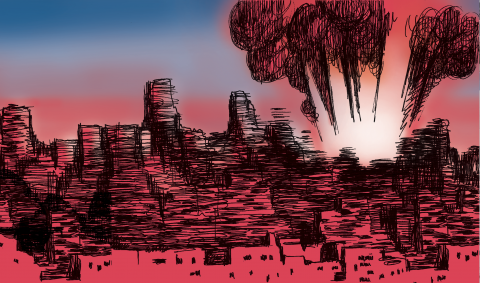عادةً ما يُعتبر المثقّفُ مؤدِّيًا لدورٍ مهمٍّ في التغيير الاجتماعيّ. ومع أنّ هذا الاعتقاد قد يكون على جانبٍ كبيرٍ من الصحّة، فإنّه لا يمكننا أن نستنتجَ تلقائيًّا أنّ التغيير الذي يجلبه المثقّفُ إلى مجتمعه ثوريٌّ بالضرورة.
ففي حالة المثقّف المستعمَر الذي يتلقّى تعليمًا نظاميًّا غربيًّا، تشكِّل المعرفةُ التي يكتسبها من هذا التعليم ارتباطًا بما هو غربيّ، وانفصالًا عن مجتمعه. وهذا الانفصال ليس انفصالًا تامًّا بالطبع، لأنّ المثقف المذكور يحاول أن يتغلّب عليه بإعادة الارتباط بمجتمعه. لكنّ هذا الانفصال، ضمن تقسيم العمل العالميّ وعلاقاتِ القوّة الاستعماريّة، يبدو للمثقّف المستعمَر نتيجةً "لتقدّمه" على مجتمعه، ولحاجة مجتمعه إلى أن "يَلحقَ" به؛ وهذا ما يعتبره المثقفُ المذكور مهمّتَه الثوريّة. غير أنّ هذه المهمّة لا تؤدّي إلّا إلى إعادة إنتاج القوّة التي أنتجتْها ما دامت تستند إلى اعتبار الغرب معيارًا لتقييم المجتمع المستعمَر، وغايةً ينبغي على هذا المجتمع أن يسعى إلى بلوغها.
هذه المداخلة تبيِّن، بالاعتماد على كتاباتٍ ثوريّةٍ مثل كتابات غسّان كنفاني وكلود مكاي وإيمي سيزير، كيف كان سعيُ المثقّفين المستعمَرين إلى التماثل مع ما هو غربيّ رأسماليّ عاملًا مهمًّا في الحفاظ على تقسيم العمل العالميّ القائم. فكلّما زادت عالميّةُ المثقّف انفصلَ عن ناسه، وزاد احتمالُ فشل/أو نجاح مشروعه بحسب الموقع الذي نتّخذه في تقسيم العمل العالميّ؛ فحين يحدَّد النجاحُ مسبّقًا بحسب درجة التماثل مع النموذج الغربيّ للمجتمع، يغدو كلُّ اختلاف في حياة المستعمَرين دليلًا على فشل اكتمال هذا التماثل.
في أدب السود، يوصَف عادةً المثقّفُ المستعمَرُ المتماثِلُ مع "سيّده" بـ"عبد المنزل" (أو العبد المدجَّن) الذي يكون ارتباطُه بسيّده قويًّا، واحتقارُه للعبيد الآخرين قويًّا أيضًا. صحيحٌ أنّ تعليمَ العبيد المدجَّنين، والميزاتِ الثقافيّةَ التي حصلوا عليها، أهّلتْهم لأن يكونوا قادةً للثورة؛ غير أنّ تربيتَهم على أيدي أسيادهم جعلتهم في علاقةٍ من المديونيّة يسدِّدونها بالطاعة المستمرّة، التي لن تنتهي إلّا عندما يأخذون مكانَ أسيادهم. لكنّ أيًّا من الخياريْن، الطاعة أو "السيادة الجديدة،" لا يغيّر في نظام الأشياء (James 1963; McKay 2000).
لقد كان التعليمُ الحديث في المستعمَرات الاستراتيجيّة الأساسيّة التي اعتمدها الغربُ الرأسماليّ في مشاريعه الاستعماريّة أو التنمويّة. فإدخالُ المستعمَرات تطلّب نوعًا من التعليم يخلق ذواتًا مطيعةً ومنمّطةً. صحيح أنّ هذا التعليم خلق أيضًا مَن ناضلوا ضدّه، بيْد أنّ هؤلاء أنفسَهم أعادوا إنتاجَ أشكال القوّة الاستعماريّة ولكنْ تحت مسمَّيات "الوطنيّة،" التي تترجَم عادةً بإنشائهم "الدولةَ القوميّة."
فالحال أنّ النخبة المتعلّمة في الدول القوميّة المستقلّة حديثًا كانت ترى في الدولة ومؤسَّساتها غايةَ النضال العليا، وترى في التعليم الأساسَ الذي يتيح بناءَ كيان حداثيّ يقوم على ذوات/موضوعات مذرَّرة ومجرَّدة تسمّى في مجموعها "الأمّة." يبيّن ماركس (في كتابه حول المسألة اليهوديّة) أنّ الانسان الذي يتحوّل، من خلال علاقته بالأمّة، إلى كيانٍ مذرَّر ومنقسمٍ إلى "مواطن" و"فرد مدنيّ،" يدخل في عقدٍ اجتماعيّ يتنازل بموجبه عن حريّته، وعن مسؤوليّته عن نفسه، وعن قدرته على الفعل، لصالح الدولة، التي تقدِّم له ــــ بدلًا من ذلك ــــ حمايةً لمصالحَ خاصّةٍ، تصبح في النهاية شرطًا لكونه مواطنًا.
إنّ تمثيلَ الإنسان من قِبل كيانٍ آخر أمرٌ يتعارض مع كونه حرًّا؛ فالتمثيل يقوم على أساس وجودِ وسيطٍ، وفي عالم التمثيل لا يستطيع الإنسانُ أن يدرك ذاتَه إلّا من خلال هذا الوسيط. هنا تكون الدولةُ هي الوسيط بين الإنسان وحرّيته (بحسب ماركس). الحريّة عند ماركس هي في الوجود المادّيّ والملموس للإنسان، وهو وجودٌ لا يقوم على فصل قدرات الإنسان السياسيّة عن قوته الاجتماعيّة (المصدر نفسه).
أتّفقُ مع مَن أكّدوا وانتقدوا عجزَ المجتمعات العربّية (والمجتمعات المستعمَرة الأخرى) عن إنتاج هذه الذوات المذرَّرة التي ينقسم كيانُها إلى قسمين: واحد حقيقيّ ومادّيّ، يقوم على الفردانيّة والأنانيّة والمصلحة الشخصيّة؛ وآخر عامّ، هو المواطن الذي لا يتحقّق إلّا من خلال مشاركته في عمليّة التمثيل. وبغضّ النظر عن استعماريّة هذه الخطابات واستشراقيّتها، فإنّ ما تراه فشلًا يبدو لي مصدرًا للأمل في وجود اختلافٍ قد يتيح مجالًا لنضالٍ تحرّريّ لا ينتهي بكيانٍ ممأسَسٍ يشرعن علاقاتِ القهر بعد أن كانت استعماريّةً تستدعي كلّ نضالٍ ضدّها.
المثقّف ليس حرًّا ولكنّه يسعى إلى أن يكون مُحرَّرًا. إنّه موضوعٌ للفعل؛ فعمليّات التعليم والتربية الحديثة التي خضع لها حوّلتْه إلى موضوع للفعل، بدلًا من أن يكون فاعلًا. بالنسبة إليه، الحريّة لا تعود فعلًا أو طريقةً في الوجود، بل حالة قانونيّة أعطيتْ إليه. لكنّ قوميّة المثقّفين المستعمَرين، التي تشكّل بالنسبة إليهم تجسيدًا لحريّتهم، لا تتلاءم مع الحريّة في حقيقة الأمر؛ ذلك لأنّ القوميّة هي الصناعة المؤسّسيّة التي أوجدها الرجلُ الأبيض، ومن خلالها يتعلّم المستعمَرُ أن يعي قضايا العِرق واللون. القوميّة، بكلمات كلود مكاي، تتعلّق بـِ"المقايضة، والتنافس، والاستغلال، والكذب، والغشّ، والصراع، والكبت، والقتلِ بين الناس. و[تتعلّق] بالتملّك أيضًا، وبالقدرة على تنظيم الصراعات ضمن نظامٍ يقوم على نهب الشعوب الأضعف." القوميّة، بالنسبة إلى مكاي، تقوم على غريزة الحضارة، التي تقوم بدورها على المِلْكيّة والضرائب، بحيث يصبح الإنسانُ موضوعًا للدولة والقانون. الحرّ في هذه الحالة هو المتمرّد، الخارجُ على القانون، ما دام "لا يعرف ما هي هذه الحضارة" (McKay 2000: 118).

موقف مكاي هذا لا يختلف كثيرًا عن موقف غسّان كنفاني. فعالمُ الحضارة، لدى كنفاني، هو عالمُ الخذلان، وفيه يَخسر الإنسانُ ما يؤمن به، ويُستبدل الإيمانُ بالشعور بالخداع، كما تُستبدَل المعرفةُ بشكٍّ مستمرّ، وما كان ذا قيمةٍ يصبح بلا قيمة. في عالم الحضارة، تكون قيمةُ الحياة أقلَّ من قيمة الآلات (قصّة كنفاني، "الخِراف المصلوبة").
ليس مصادفةً أنّ أغلبَ قصص كنفاني أدانت المثقّفَ أو المتعلّمَ باعتباره إنسانًا فردانيًّا ونفعيًّا. ونفعّيتُه هي التي تقودُه، أحيانًا، إلى موقفٍ عدميّ، ما دام محتاجًا إلى أن يحدِّد مقابِلًا لكلِّ فعلٍ يفعلُه. المثقف، عند كنفاني، يشعر بالمسؤوليّة دومًا، فيقوم بعمليّات حسابيّة، ولا يجازف، لأنّ المجازفة تعني الدخولَ في عالم اللاعقلانيّ، فتنفي ذاتَه كمثقف. مسؤوليّة المثقّف، لدى كنفاني، هي الحفاظ على النظام؛ فالمثقّف يتبع القانونَ ما دام القانونُ هو المسيطر. وشعورُه بالمسؤوليّة يعني أن لا يقوم بالفعل لذاته، أو يتحمّل مسؤوليّة ذاته، بل يحيل هذه المسؤوليّة على كيانٍ خارجيّ يمثّله باعتباره الذات/الموضوع المثاليّة. وهذا يتضمّن أن ينضمّ المثقفُ إلى ثورة الناس فقط عندما يشعر أنها تتغلّب عليه وعلى النظام الذي يحافظ عليه. أمّا الثوريّ، بحسب كنفاني، فلا يتبع منطقًا نفعيًّا، أيْ لا يحسب الفائدةَ من وراء الفعل، بل يَخلق معيارَه الخاصّ للأشياء، ويجد قوّتَه في مواجهته لمعاناته بدلًا من عقلنتها أو كبتها.
المثقّف يظهر في نصوص كنفاني مفتقرًا إلى المعرفة؛ قد يحيل على كتب، ولكنّه في أغلب الأوقات يفشل في معرفة الحياة، بما في ذلك حياتُه. إنّه يبحث عن ذاته وحياته في حياة الآخرين، التي يَفرضها عليهم عندما يحوّلهم إلى موضوعاتٍ للمعرفة التي ينتجُها. لكنّ ما يراه في موضوع دراسته هو ما لا يريد أن يراه من حياته: حياة ضائعة، لا معنى ولا فائدة لها، "تسير على نفس الطريق، في نفس الاتجاه، على نفس الجانب، ونفس الأفق، ونفس كلّ شيء" (كنفاني، "قلعة العبيد").
إنّ ما ينتجه المثقّفُ من "معرفة" إنّما هو، في تصوير كنفاني، انعكاسٌ لذاته المنفصلة عن ذاتها ومجتمعها. فالمثقّف لا يمكنه أن يتحدّث عمّن يعيشون ضمن نظمٍ قيميّةٍ أخرى، ترتبط بنمط حياةٍ وفعلٍ آخر. المثقّف، في بحثه عمّا يتوقّع ويريد أن يجدَه في حياةِ مَن يصوِّرُهم، لا يمكنه أن يرى ما هو موجودٌ أمامه فعلًا؛ وفي بحثه عن الأمور غير الموجودة لن يَحصد إلّا خيبةَ الأمل. لكنّه لا يدرك هذه الأخيرةَ في وصفها خيبةً لأنّه يُلصقها بالآخر، موضوعِ دراسته، الذي يعتبره المثقفُ لاعقلانيًّا ولامنطقيًّا ما لم يتمكّن من إدخاله ضمن إطاره العقلانيّ والمنطقيّ. المثقّف، في أعمال كنفاني، لا يُسائل إطارَه المعرفيّ، ولا يُسائل موقفَه، بل يَفرض ما هو موجودٌ في ذاته على الآخرين، الذين يكون عليهم ــــ إذّاك ــــ أن يحملوا عبءَ اغترابه عن ذاته.

إنّ الإدانة في نصوص كنفاني ومكاي ليست إدانةً للعلم والمعرفة في ذاتهما، بل إدانة لإنتاج مثقّفي العالم الثالث حين يوالون أسيادَهم المستعمِرين. يبيّن كنفاني إنّ المثقف لا يكون ثوريًّا إلّا عندما ينسجم مع مجتمعه وسماته، ويتوافق مع جذوره الثقافيّة الحقيقيّة (بحسب كتاب معارج الإبداع). وهذا يتضمّن الثورةَ على التعليم حين يخلق ذاتًا منصاعةً، بدلًا من ذاتٍ ناقدةٍ ومتمرّدةٍ على كلّ محاولات الضبط الاستعماريّ. ونموذجُ مثل هذه الذات المتمرّدة نجده عند كنفاني وسيزير في الشاعر الصعلوك أو المتمرّد. فلكي يكون المثقّفُ متمرّدًا فإنّ عليه أن يتخلّص من تربيته، ومن ذاته التي خضعتْ لتعليم المستعمِر؛ عليه أن يكون "شاعرًا": ذلك لأنّ الشاعر هو وحده القادرُ على أن يغيّر في قواعد اللغة والمعرفة والممارسة.
على أنّ قوة الشاعر المتمرّد ليست إلهيّةً أو نبويّة، على ما يصوَّر في إيديولوجيا الفردانيّة. قوته، بحسب كنفاني وسيزير، هي في قدرته على مواجهة معاناته تحت الاستعمار، وفي مقاومته له، بدلًا من عمليّات الكبت والتعويض والإزاحة و"التسامي" التي يعتمدها المثقفُ الرأسماليّ ولا تؤدّي إلّا إلى إعادة إنتاج الوضع القائم.
المثقفُ الثوريّ عند سيزير يرفض أن يقف من الأشياء موقفَ المتفرِّج الذي يعيش حياةً عقيمة، لكنّه يرفض أيضًا أن يجد غايةَ وجوده في تحويل شعبه إلى محض موضوعٍ للكتابة، أو أن ينصِّب نفسَه "واهبَ صوتٍ" للمقموعين، بل يجد قوتَه وصوتَه في نضالهم الحرّ.
بالنسبة إلى كنفاني، فإنّ المثقّف لن يعلّم الناسَ شيئًا ما لم يكن واحدًا منهم، أيْ ما لم ينزلْ من شرفته العالية إلى الشارع. فأن ينصِّبَ نفسَه قائدًا للناس، أو معلِّمًا لهم، أو محرِّرًا لهم، فذلك يعني أنّه يعيدُ إنتاجَ الفصل الطبقيّ، فيكون من ثمّ غيرَ ثوريّ. وفي هذا الصدد نذْكر أنّ والتر بنيامين كان يقول إنّ ما يحدِّد مكانَ المثقف في النضال الطبقيّ هو موقعُه في عمليّة الإنتاج؛ فلا يكفي أن يكتب المثقفُ "الثوريّ" عن موضوعاتٍ ثوريّة، وإنّما عليه أن يتحدّى النظامَ الإنتاجيّ الذي تفرضه الطبقاتُ الحاكمة، وإلّا فإنّ ما ينجزه ليس إلّا إعادةَ إنتاج نمط الإنتاج البرجوازيّ، الذي سيتمكّن في النهاية من احتواء المضامين الثوريّة واستيعابها(“The Author as Producer”)
إنّ المثقّف الذي تنفصل رؤيتُه الثوريّة عن حياته المادّيّة ليس لديه ما يعلِّمُه الناسَ، بحسب كنفاني. بل إنّه، بذاته القائمة على "المسؤوليّة العقلانيّة" التي تتراجع أمام الفعل المقاوم، يجد نفسَه ضئيلًا أمام الطبقات الفقيرة الثائرة والشجاعة. المثقّفون، كما يصفهم كنفاني، لم يتخرّجوا بعدُ من مدرسة الجماهير، المعلِّمِ الحقيقيِّ الدائم (رواية أم سعد). في لحظات الثورة، يدرك المثقّف أنّ لدى الناس معرفةً لا يمكنه الحصولُ عليها إلّا من خلال تواصله معهم، ومعرفةِ أمثالهم الشعبيّة وحكاياتهم. لكنّ هذا الادراك يأتي ردًّا على فعلٍ لم يكن المثقفُ هو مَن قام به. ومن هنا كان تأكيد كنفاني أنّ المثقّف، بدوره هذا، ليس معلِّمًا أو قائدًا للجماهير، بل العكس هو الصحيح.
ثمّ إنّ المثقّف الثوريّ ليس بالضرورة مَن يكتب أدبًا "ملتزمًا،" أو ذا معرفةٍ تلتزم بقواعدَ ماركسيّةٍ أو غيرها. فإذا عنى "الأدبُ السياسيّ" إخفاءَ ما لا ينسجم مع الواقع، وكبْتَ جزءٍ أساسٍ من ذات الكاتب، والتزامَ القوالب الجاهزة، فلن يكون الكاتبُ ثوريًّا. إنّ التزامَ قواعد "الأدب السياسيّ" يعني أن يكون الكاتبُ حبيسًا للمعرفة كمؤسّسة ذاتِ أبوابٍ مغلقة، وحدودٍ واضحةٍ غيرِ قابلة ِللاختراق. أما الكاتب الثوريّ الحقيقيّ فيؤْثِر التخلّصَ من قواعد الإنتاج المعرفيّ على أن يسير وفقها ويعيدَ إنتاجَها بالطريقة التي تعمل بها المصانعُ الرأسماليّةُ أو مزارعُ العبيد، بحسب وصف إيمي سيزير The Collected Poetry)).
الخوف هنا أن تتحوّل الكتابة "الملتزمة" إلى مجرّد محاولةٍ لإرضاء الذات القاصرة عن الفعل الثوريّ، فتكون مسوِّغًا للتخاذل، و"تعويضًا" يعيد إنتاجَ القائم. أما الكتابة الثوريّة فتسعى إلى مصادر معرفةٍ غير تلك التي تخضع لسيطرة الإيديولوجيا السائدة؛ وهو ما يعني عادةً أن تتجاوز ما هو ممأسَس على الـ"منطقيّ" والـ"عقلانيّ،" وأن تَحمل أبعادًا ممّا هو شعريّ. وبذلك تخلق مساحاتٍ تتيح لها تصوّرَ عالمٍ آخر لا يقوم على الهروب ممّا هو موجود، بل على مواجهته. الكتابة الثوريّة معركة، والحقيقةُ تتحدّد بالمجازفة التي يقوم بها الكاتب: فبدلًا من أن يَنسبَ إلى الناس ما ليس فيهم، عليه أن يعترف بأنّ معرفتَه مجزوءة، وبأنّ ثورّيتها تكمن في خلخلةِ ما هو غيرُ جديرٍ بالبقاء.
في مقابل المثقّف الذي تقيّده أسئلتُه الوجوديّة، يضع كنفاني الصعاليكَ الذين ثاروا وحملوا مسؤوليّةَ ثورتهم. الصعلوك لا يملك إلّا الحصانَ والسيف والموقف؛ الإيمانُ بالقضيّة يشكّل كما يرى كنفاني مصدرَ القوّة التي أتاحت للشاعر الصعلوك أن يكون مثقفًا ثوريًّا بامتياز، بدلًا من القيود التي تفرضها الأكاديميا ومؤسّساتُ النشر على المثقّف المدجَّن (راجعوا مقالات فارس فارس لغسّان كنفاني).
بالنسبة إلى كنفاني، كما إلى سيزير ومكاي، ينتمي المثقفُ الثوريّ إلى الجميع، ولا ينتمي إلى أحد في الوقت نفسه. كنفاني لم يكن، يومًا، محسوبًا على "المثقفين." عاش بالحدس، محتفلًا بالحياة في كلّ لحظاتها، وسيلةً لكي يُبعد نفسَه عن عالم المثقّف الذي يعاني المللَ والعزلةَ والسلبيّةَ. هذا النأي عن عالم المثقفين كان، على الأغلب، وراء وصف فضل النقيب له بالغرور؛ فكنفاني، كما يصفه النقيب، لم يكن يشكّ في قيمة عمله، أو يشعر بالحاجة إلى الاعتذار عمّا يكتبه. لكنّ أكثرَ ما استفزّ النقيبَ في كنفاني أنّه لم يَكنّ أيَّ احترام للحلقات الأدبيّة والفكريّة، بل أراد أن يدمِّر عالمَ المثقفين المعزولين ويرميهم ــــ مع شكوكهم ــــ في الشارع! ولم يكن غسّان متواضعًا إلّا أمام منَ "يذوبون" وهم يناضلون من أجل الحياة (أمّ سعد، ص235)، لا لأنّه لا يثق في كتابته، بل بسبب يقينه أنّ الكتابة لا يمكنها أن تقولَ كلَّ شيء، بل يبقى دائمًا ما لم يُعرفْ أو يُكتبْ أو يُفعلْ بعد، ما دامت ثمّة حياةٌ، ونضالٌ من أجل هذه الحياة.
فلسطين
المراجع
غسان كنفاني، معارج الإبداع: ما لم يُنشر من الكتابات الأولى للشهيد الأديب غسّان كنفاني ما بين 1951-1960، تحرير عدنان كنفاني (دمشق: مؤسّسة فلسطين للثقافة،2009 ).
---، فارس فارس (بيروت: دار الآداب، 1996).
---، أم سعد، في: الآثار الكاملة، مجلد 1، ط 4 (بيروت: مؤسّسة غسّان كنفاني الثقافيّة، 1994).
---، "الخراف المصلوبة،" في: الآثار الكاملة، مجلد 2، ط 3 (بيروت: مؤسّسة غسان كنفاني الثقافيّة، 1987).
---، "قلعة العبيد،" في: الآثار الكاملة، مجلد 2، ط 3 (بيروت: مؤسّسة غسّان كنفاني الثقافيّة، 1987).
فضل النقيب، هكذا تنتهي القصص، هكذا تبدأ: انطباعات شخصيّة عن حياة غسّان كنفاني وباسل الكبيسي (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربيّة، 1983).
.(Walter Benjamin, “The Author as Producer,” In Reflections, Trans. Edmund Jephcott, Ed. Peter Demetx (New York: Schocken Books, 1986
.Aimé Césaire, The Collected Poetry, Trans. Clayton Eshleman and Annette Smith (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1983
.Karl Marx, “On The Jewish Question,” In The Marx –Engels Reader, 2nd edition (Robert Tucker, ed.), (New York and London: W.W. Norton and Company, 1978), p. 26-52
.(Claude McKay, Banjo (London: X Press, 2000
.(CLR James, The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution. (New York: Vintage, 1963